رامز الحمصي
تُعد العلاقة بين القيادة السياسية والقضايا المصيرية، لا سيما تلك المتعلقة بالصراعات الإقليمية، محورًا أساسيًا لفهم ديناميكيات الدول وتوجهاتها الاستراتيجية. في سياق الشرق الأوسط، لطالما شكل الصراع العربي الإسرائيلي قضية مركزية، أثرت بشكل عميق على السياسات الداخلية والخارجية للدول العربية. يهدف هذا البحث إلى الغوص في تحليل معمق لتجربتين سياسيتين سوريتين بارزتين في التعامل مع إسرائيل: تجربة الرئيس الراحل حافظ الأسد (1970-2000) وتجربة الرئيس الانتقالي الحالي أحمد الشرع. سيناقش البحث ما إذا كان نهج الشرع يمثل استنساخًا لنمط الأسد، أم أنه يسبح بتيار مختلف، مع الأخذ في الاعتبار التحولات الأيديولوجية والسياسية والقيود التي تفرضها المنظومة السياسية الدولية.
إن قراءة تجربة حافظ الأسد في التعامل مع إسرائيل بعد وصوله إلى سدة الحكم، خصوصًا من الناحية الأيديولوجية والسياسية، تكشف عن تعقيدات بالغة. فبينما كان حزب البعث الذي ينتمي إليه الأسد يرى إسرائيل عدوًا وجوديًا، إلا أن الأسد لم يتردد في الجلوس على طاولة التفاوض عندما اقتضت مصالح الحكم ذلك. هذا التناقض الظاهري بين المعتقدات الأيديولوجية والبراغماتية السياسية يشكل نقطة محورية في فهم سياسته.
في المقابل، يروج المحيطون بأحمد الشرع إلى أن تجربته تنتمي إلى نمط سياسي مختلف، لا يخضع لإكراهات الأطر الأيديولوجية الجامدة، ولا يقيد نفسه بثوابت مفترضة لا تستند إلى واقع أو مصلحة وطنية عليا. يُزعم أن الشرع يدير مسارات الفعل الوطني بأدوات مرنة ولكن بأهداف صلبة، مع التركيز على معيار المصالح الوطنية والاستراتيجية، والحفاظ على الثوابت السيادية والكرامة الوطنية، دون الوقوع في أوهام الشعارات أو التهويل السياسي. هذا الطرح يثير تساؤلات حول مدى أصالة هذا النهج ومدى اختلافه عن سابقه.
سيعود البحث إلى معلومات وأوراق وتحليلات من عام 1970 حتى عام 2025، لتقديم نقاش عميق مبني على دلائل، ويهدف للوصول إلى تحليل شامل والتركيز على تحليل الدلائل التي تدعم أو تدحض فكرة الاستنساخ، مع الأخذ في الاعتبار السياق الإقليمي والدولي المتغير، ودور المنظومة السياسية الدولية في تحديد مسارات الدول العربية. هل ستسمح هذه المنظومة للشرع بالذهاب نحو تيار مختلف، أم أنها ستعيده للمنظومة السياسية العربية المتبعة منذ عام 1970؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي سيسعى المقال للإجابة عليه من خلال مقاربة تحليلية معمقة.
الفصل الأول: أيديولوجيا حزب البعث وتجربة حافظ الأسد مع إسرائيل (1970-2000)
1.1 أيديولوجية حزب البعث تجاه إسرائيل قبل 1970
تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق عام 1946 على يد ميشيل عفلق وصلاح البيطار وزكي الأرسوزي، كحركة قومية عربية تهدف إلى تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية للأمة العربية. كانت الأيديولوجية البعثية في جوهرها مناهضة للاستعمار والصهيونية، وتعتبر إسرائيل كيانًا مصطنعًا وغاصبًا للأرض العربية، وتهديدًا وجوديًا لمشروع الوحدة العربية [1]. لم تكن إسرائيل مجرد دولة معادية، بل كانت تُصوّر كأداة للمشروع الاستعماري الغربي في المنطقة، تهدف إلى تقسيم الأمة العربية وإضعافها [2].
فلسطين، بكل أبعادها التاريخية والجغرافية، كانت جزءًا لا يتجزأ من الأراضي العربية في الفكر البعثي. وبالتالي، كان تحرير فلسطين واستعادة الحقوق العربية هدفًا أساسيًا ومقدسًا للحزب. تجلى هذا الموقف في الأدبيات البعثية والخطابات السياسية التي كانت تدعو إلى الكفاح المسلح والمقاومة الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي. كانت الشعارات مثل "الوحدة، الحرية، الاشتراكية" تتردد مع شعارات تحرير فلسطين، مما يعكس الارتباط الوثيق بين المشروع القومي العربي والصراع ضد إسرائيل [3].
قبل عام 1970، شهدت سوريا سلسلة من الانقلابات العسكرية التي أثرت على مسار حزب البعث وتوجهاته. فبعد انقلاب عام 1963 الذي أوصل البعثيين إلى السلطة، ثم انقلاب عام 1966 الذي نفذه الجناح اليساري المتشدد داخل الحزب، أصبحت الأيديولوجيا تلعب دورًا أكثر بروزًا في السياسة السورية. ومع ذلك، حتى في هذه الفترة، كانت المصالح السياسية الداخلية والخارجية غالبًا ما تتداخل مع الأيديولوجيا، وأحيانًا تتفوق عليها. على سبيل المثال، كان الصراع على السلطة داخل الحزب يؤثر على كيفية تطبيق المبادئ الأيديولوجية، وكيفية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية [4].
بالإضافة إلى ذلك، كانت أيديولوجية البعث تركز على بناء دولة قوية ومركزية، قادرة على قيادة المشروع القومي العربي. هذا التركيز على الدولة القوية كان يعني أن الحزب كان يسعى للسيطرة على جميع مفاصل الدولة والمجتمع، لضمان تطبيق مبادئه وأهدافه. وفي هذا السياق، كانت قضية فلسطين تُستخدم كأداة لتعزيز شرعية الحزب وسلطته، وتعبئة الجماهير خلف قيادته.
كانت النظرة إلى إسرائيل في هذه الفترة تتسم بالعداء المطلق، حيث لم يكن هناك أي مجال للتفاوض أو الاعتراف بوجودها. كانت أي محاولة للتقارب مع إسرائيل تعتبر خيانة للمبادئ القومية. وقد ساهمت حرب عام 1967، وما نتج عنها من احتلال للجولان، في ترسيخ هذه النظرة العدائية، وجعلت من استعادة الأراضي المحتلة أولوية قصوى، ولكن من منظور الكفاح والمقاومة، وليس التفاوض [5].
1.2 حافظ الأسد: من الأيديولوجيا إلى الواقعية السياسية
بعد وصول حافظ الأسد إلى سدة الحكم في سوريا عام 1970، عبر ما عُرف بـ"الحركة التصحيحية"، شهدت السياسة السورية تحولًا نوعيًا في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الصراع مع إسرائيل. على الرغم من أن الأسد كان جزءًا لا يتجزأ من حزب البعث ويتبنى أيديولوجيته القومية والاشتراكية، إلا أن سياسته اتسمت بخليط فريد من العداء الأيديولوجي المتوارث والواقعية السياسية البراغماتية التي تهدف إلى تحقيق المصالح السورية العليا واستقرار نظامه [6].
كانت أيديولوجية البعث تعتبر إسرائيل كيانًا عدوًا يجب مقاومته وتحرير الأراضي المحتلة منه. ومع ذلك، أدرك الأسد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مقاربة أكثر مرونة من مجرد التمسك بالشعارات. فبعد حرب أكتوبر 1973، التي أظهرت محدودية الخيار العسكري وحده، انخرط الأسد في مفاوضات متعددة مع الجانب الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بوساطة أمريكية [7].
من أبرز محطات هذه المفاوضات كانت مفاوضات جنيف (1999-2000) التي جرت تحت رعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. كادت هذه المفاوضات السرية أن تسفر عن اتفاق سلام شامل بين سوريا وإسرائيل، يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هضبة الجولان المحتلة. هذا الاستعداد للتوصل إلى اتفاق سلام، حتى لو كان ذلك يعني الاعتراف الضمني بوجود إسرائيل، يعكس براغماتية الأسد وقدرته على تجاوز الخطوط الحمراء الأيديولوجية عندما تخدم المصالح الوطنية العليا [8].
كما كشفت وثائق إسرائيلية رُفعت عنها السرية عن مفاوضات جرت في عام 1974 بوساطة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر. هذه المفاوضات أدت إلى توقيع اتفاقية فصل القوات في الجولان، والتي جمدت الصراع على الجبهة السورية لسنوات طويلة. هذه الخطوات، التي قد تبدو متناقضة مع الخطاب الأيديولوجي للحزب، تشير إلى أن الأسد كان مستعدًا للجلوس على طاولة التفاوض عندما يخدم ذلك مصالح سوريا، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأراضي المحتلة وتأمين الحدود [9].
كانت دوافع الأسد للتفاوض متعددة. أولاً، كانت استعادة هضبة الجولان المحتلة أولوية قصوى بالنسبة له، ليس فقط لأسباب سيادية، بل أيضًا لتعزيز شرعيته الداخلية. ثانيًا، كان استقرار نظامه ومصالحه الحُكمية دافعًا رئيسيًا. فالمفاوضات، حتى لو لم تسفر عن سلام كامل، كانت تساهم في تخفيف التوتر على الحدود وتوجيه الموارد نحو التنمية الداخلية وتعزيز قبضة النظام [10]. ثالثًا، كانت استراتيجية الأسد تهدف إلى "كبح جماح الحلم الإسرائيلي الكبير"، أي منع إسرائيل من التوسع أو فرض هيمنتها على المنطقة. وقد نجح في ذلك إلى حد كبير من خلال الحفاظ على توازن القوى والضغط الدبلوماسي [11].
على صعيد العلاقات الإقليمية، وبعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، أقامت سوريا علاقات وثيقة مع طهران. جمع بين البلدين العداء المشترك تجاه العراق وإسرائيل، وعدم الثقة تجاه الغرب. هذه العلاقة الاستراتيجية مع إيران سمحت للأسد بتعزيز موقفه الإقليمي وتوفير عمق استراتيجي في مواجهة التحديات [12]. حكم الأسد سوريا بقبضة حديدية لمدة ثلاثة عقود، مما منحه سلطة مطلقة لاتخاذ قرارات سياسية قد تبدو متناقضة مع الخطاب الأيديولوجي للحزب، ولكنها تخدم استقرار نظامه ومصالحه الاستراتيجية العليا.

الفصل الثاني: المنظومة السياسية الدولية وتأثيرها على الدول العربية (1970-2025)
2.1 تحولات النظام الدولي وتأثيرها على المنطقة
شهدت المنظومة السياسية الدولية منذ عام 1970 تحولات عميقة أثرت بشكل مباشر على الدول العربية وسياستها الخارجية، وشكلت الإطار الذي تحركت ضمنه قيادات مثل حافظ الأسد، وتتحرك ضمنه الآن قيادات مثل أحمد الشرع. قبل هذه الفترة، وتحديدًا في مرحلة ما بعد الاستقلال، كانت القومية العربية هي التيار الأيديولوجي المهيمن، بقيادة شخصيات كاريزمية مثل جمال عبد الناصر في مصر. كان الهدف الرئيسي هو بناء نظام إقليمي عربي موحد وقوي، قادر على مواجهة المشاريع الاستعمارية الغربية وإسرائيل [13]. إلا أن هزيمة عام 1967، ووفاة عبد الناصر في عام 1970، شكلا نقطة تحول، حيث بدأت مرحلة جديدة اتسمت بتغيرات في التوجهات السياسية للدول العربية.
منذ السبعينات، بدأت الدول العربية تتبنى سياسات خارجية أكثر واقعية، مدفوعة بالمصالح الوطنية المحددة بدلاً من الأيديولوجيات القومية الصارمة. هذا التحول لم يكن اختياريًا بالكامل، بل كان نتيجة لتأثير عوامل خارجية وداخلية متعددة. على الصعيد الخارجي، أدت نهاية الحرب الباردة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات إلى تغيير جذري في موازين القوى الدولية. فمع انهيار الاتحاد السوفيتي، اختفى القطب الثاني الذي كانت بعض الدول العربية تعتمد عليه في موازنة النفوذ الأمريكي. هذا التحول أدى إلى نظام عالمي أحادي القطبية، حيث أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة. هذا الوضع فرض قيودًا جديدة على الدول العربية، وأجبرها على إعادة تقييم تحالفاتها وسياساتها الخارجية لتتناسب مع هذا الواقع الجديد [14].
كما أدت التدخلات الأجنبية المتزايدة في المنطقة، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، إلى تقييد هامش المناورة للدول العربية. فالحرب على الإرهاب، والتدخلات في العراق وأفغانستان، ثم لاحقًا في ليبيا وسوريا، كلها عوامل أثرت على استقرار المنطقة وديناميكياتها السياسية. هذه التدخلات، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية التي تعاني منها العديد من الدول العربية، مثل أزمة الحوكمة، والضغوط الاقتصادية، والتحديات الاجتماعية، كلها أثرت على قدرة هذه الدول على تشكيل سياساتها بشكل مستقل وفعال [15].
في هذا السياق، أصبحت السياسة الخارجية للدول العربية تتسم بـ"العزلة النسبية" في بعض الفترات، حيث ركزت كل دولة على مصالحها الخاصة واستقرارها الداخلي، بدلاً من الانخراط في مشاريع قومية كبرى. هذا التوجه أدى إلى تراجع فاعلية العمل العربي المشترك، وتزايد الانقسامات بين الدول العربية، مما أثر سلبًا على قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بشكل موحد، فهذه التحولات في النظام الدولي، من ثنائية القطبية إلى أحادية القطبية، ثم إلى نظام متعدد الأقطاب مع صعود قوى جديدة مثل الصين وروسيا، كلها عوامل أثرت على هامش المناورة للدول العربية. فبينما كانت بعض الدول تستفيد من التنافس بين القطبين، أصبحت الآن تواجه تحديات جديدة في ظل نظام عالمي أكثر تعقيدًا وتنافسية. هذا الواقع الجديد هو الذي يشكل الإطار الذي يتحرك ضمنه أحمد الشرع، ويحدد مدى قدرته على صياغة سياسة خارجية مستقلة [16].
2.2 الصراع العربي الإسرائيلي في سياق التحولات الدولية
في سياق هذه التحولات الدولية والإقليمية، تأثر الصراع العربي الإسرائيلي بشكل كبير. فبعد أن كان الصراع يُنظر إليه على أنه صراع وجودي لا يقبل الحلول الوسط، بدأت بعض الدول العربية في الانخراط في مفاوضات سلام مع إسرائيل. هذا التوجه، الذي كان يعتبر محظورًا في السابق من منظور القومية العربية، أصبح مقبولًا تحت مظلة الواقعية السياسية وتقديم المصالح الوطنية العليا [17].
تجلت هذه التحولات في توقيع اتفاقيات سلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية، مثل مصر في عام 1979 والأردن في عام 1994، ولاحقا اتفاقيات إبراهيم أو الاتفاقيات الإبراهيمية التي عُقِدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة عام 2020، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين ثم انضمت كل من المغرب والسودان إلى الاتفاق. هذه الاتفاقيات عكست تبني سياسة "العزلة النسبية" التي ذكرناها سابقًا، حيث ركزت هذه الدول على مصالحها الخاصة. فمصر، التي كانت رائدة في القومية العربية، اختارت طريق السلام لاستعادة أراضيها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حتى لو كان ذلك يعني الابتعاد عن الإجماع العربي التقليدي [18].
إن هذا التحول لم يكن سهلاً، فقد واجه معارضة شديدة من بعض الدول العربية التي رأت فيه خيانة للقضية الفلسطينية. ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقيات أظهرت أن المنظومة الدولية، وخاصة الولايات المتحدة، كانت قادرة على ممارسة ضغوط كبيرة على الأطراف الإقليمية لدفعها نحو السلام. كما أنها كشفت عن تراجع في فاعلية العمل العربي المشترك، حيث أصبحت كل دولة تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الخاصة، بدلاً من الالتزام بموقف عربي موحد.
إن تعقيد المشهد السياسي الإقليمي والدولي أثر أيضًا على طبيعة العلاقات بين الدول العربية نفسها. فالدراسات تشير إلى أن بعض الدول العربية التي تعاملت مع أنظمة مثل نظام الأسد، فعلت ذلك اضطرارًا أو خوفًا، مما يعكس غياب التنسيق الفعال والوحدة في مواجهة التحديات المشتركة. هذا التشرذم في الموقف العربي سمح للقوى الدولية والإقليمية بلعب أدوار أكبر في المنطقة، وتشكيل مسارات الصراع والتحالفات [19].
تأثر الصراع العربي الإسرائيلي أيضًا بتغير طبيعة التهديدات في المنطقة. فبعد أن كان التركيز على الصراع التقليدي بين الجيوش، أصبح هناك تركيز متزايد على التهديدات غير التقليدية، مثل الإرهاب والتطرف. هذا التحول دفع بعض الدول العربية وإسرائيل إلى إقامة علاقات غير معلنة أو شبه علنية، بهدف مواجهة هذه التهديدات المشتركة. هذا التقارب، الذي كان يعتبر مستحيلاً في السابق، يعكس مدى التغير في الأولويات الإقليمية.
على سبيل المثال، أدت الحرب الأهلية السورية التي أنتجها الأسد الابن بعد اندلاع الثورة من درعا في آذار عام 2011 إلى تعقيد المشهد بشكل غير مسبوق. فبينما كانت سوريا في عهد حافظ الأسد تعتبر جزءًا من محور الممانعة ضد إسرائيل، أصبحت الحرب الأهلية ساحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية، وأصبحت إسرائيل طرفًا غير مباشر في الصراع، من خلال استهداف مواقع معينة داخل سوريا أو دعم بعض الأطراف. هذا الوضع أظهر كيف أن التحولات الداخلية في الدول العربية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الصراع الإقليمي [20].
إن هذه التحولات في المنظومة السياسية الدولية، وتأثيرها على الدول العربية والصراع العربي الإسرائيلي، تشكل الخلفية التي يجب أن نفهم من خلالها تجربة أحمد الشرع. فهل سيتمكن الشرع من السباحة ضد تيار هذه المنظومة، أم أنه سيضطر إلى الانصياع للقيود التي تفرضها، كما فعل العديد من القادة العرب قبله؟ هذا السؤال يظل مفتوحًا، وسنحاول الإجابة عليه في الفصول القادمة.
الفصل الثالث: أحمد الشرع: منهج جديد أم استنساخ لنمط سابق؟
3.1 أحمد الشرع: التحول والمنهج السياسي
يمثل أحمد حسين الشرع، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، ظاهرة فريدة في المشهد السياسي السوري والإقليمي. فبعد أن كان قائدًا لتنظيم جهادي (جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام)، شهد مساره تحولًا جذريًا، توج بوصوله إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية الانتقالي في يناير 2025 [21]. هذا التحول من قيادة عسكرية ذات خلفية أيديولوجية متشددة إلى شخصية سياسية براغماتية يثير تساؤلات عميقة حول منهجه السياسي وما إذا كان يمثل قطيعة حقيقية مع الأنماط السابقة.
يروج المحيطون بالشرع، وبعض التحليلات السياسية، إلى أن منهجه لا يخضع لإكراهات الأطر الأيديولوجية الجامدة، بل يركز بشكل أساسي على المصالح الوطنية والاستراتيجية العليا. هذا الطرح يشير إلى أن الشرع يتبنى خطابًا سياسيًا متوازنًا، يسعى من خلاله إلى بناء علاقات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي كانت تدعم النظام السابق [22]. هذا النهج يختلف عن النماذج السياسية التقليدية التي كانت سائدة في المنطقة، سواء في السياق القومي العربي الذي يميل إلى الشعارات الرنانة، أو ضمن التيارات الإسلامية الكلاسيكية التي قد تلتزم بحدود أيديولوجية صارمة [23].
يتعامل الشرع مع المسائل السياسية بناءً على معيار المصالح الوطنية والكرامة السيادية، دون الانجرار وراء الشعارات أو التهويل السياسي. هذا يعني أن قراراته وتوجهاته تستند إلى قراءة دقيقة للواقع وتوازنات القوى، وليس إلى ثوابت مفترضة لا تستند إلى واقع أو مصلحة وطنية عليا. فكثير مما يروج له على أنه من الثوابت، إنما هو في جوهره اجتهاد سياسي ظرفي تجاوزه الواقع وتطورت حوله أدوات الفعل السياسي.
إن منهجيته الهادئة والمركبة، كما يصفها البعض، تدير مسارات الفعل الوطني بأدوات مرنة ولكن بأهداف صلبة، لا تنحرف ولا تتبدل. هذا يعني أن الشرع يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية واضحة، ولكن بوسائل تتسم بالمرونة والتكيف مع الظروف المتغيرة. هذا التوجه يهدف إلى مراكمة المنجز وتجاوز الشعارات، والتعامل مع الدولة والمجتمع كمساحة استراتيجية مركبة تدار بمزيج من الحكمة والقراءة الدقيقة للتوازنات.
3.2 موقف الشرع من التفاوض مع إسرائيل
يُعد موقف أحمد الشرع من التفاوض مع إسرائيل من أبرز النقاط التي تثير الجدل وتكشف عن مدى براغماتيته السياسية. ففي حين كانت ايديولوجيته السابقة ترفض أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل، تشير التقارير الحالية إلى أن دمشق، تحت قيادته، تجري مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء. الهدف المعلن لهذه المفاوضات هو "تهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة" [24]. هذا التوجه يمثل تحولًا كبيرًا، ويعكس استعداد الشرع للتعامل مع إسرائيل من منظور واقعي يخدم المصالح السورية، حتى لو كان ذلك يعني التفاوض مع كيان كان يعتبره سابقًا عدوًا وجوديًا.
إن هذا الاستعداد للتفاوض، حتى لو كان غير مباشر، يتماشى مع منهجه الذي يركز على المصالح الوطنية والاستراتيجية العليا. فبالنسبة للشرع، لا يتم تقييم المسائل بعناوينها الأيديولوجية، بل تخضع لمعيار المصالح الوطنية والاستراتيجية، مع الحفاظ على الثوابت السيادية والكرامة الوطنية، دون الوقوع في أوهام الشعارات أو التهويل السياسي [25]. هذا يعني أن الشرع قد يرى في التفاوض وسيلة لتجنب صراعات مكلفة، أو لتحقيق مكاسب معينة لسوريا، أو لتثبيت الاستقرار في مرحلة انتقالية حساسة.
ومع ذلك، هناك تباين في الآراء حول هذا المنهج. فبينما يرى البعض أن هذا التحول هو دليل على نضج سياسي وبراغماتية ضرورية للتعامل مع الواقع المعقد، يرى آخرون، بمن فيهم بعض الأطراف الإسرائيلية، أن الشرع لا يزال "متشددًا وعدوًا". كما أن هناك من يشكك في مدى أصالة هذا التحول، ويعتبره جزءًا من "مسرحية سياسية" تهدف إلى كسب الشرعية الدولية أو تحقيق أهداف أخرى.
تتضمن التقارير الإعلامية إشارات إلى لقاءات بين الشرع ومسؤولين إسرائيليين، مما أثار تفاعلاً واسعًا. ففي مايو 2025، صرح الشرع بأن دمشق تفاوض إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع [26]. وفي يوليو 2025، أثارت تقارير عن لقاء مباشر بين الشرع ومسؤولين إسرائيليين تفاعلاً واسعًا، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي [27]. هذه التطورات تشير إلى أن هناك قنوات اتصال مفتوحة، وأن الشرع مستعد للانخراط في حوار، حتى لو كان حساسًا ومثيرًا للجدل.
إن هذا الموقف من التفاوض مع إسرائيل يضع الشرع في مقارنة مباشرة مع حافظ الأسد. فكلاهما، رغم اختلاف خلفياتهما الأيديولوجية، أظهرا استعدادًا للتعامل مع إسرائيل من منظور واقعي يخدم المصالح الوطنية. ولكن هل هذا التشابه يعني استنساخًا للنمط، أم أنه مجرد تقارب في الأساليب نتيجة لضغوط الواقع؟ هذا ما سنناقشه في القسم التالي.
3.3 هل يستنسخ الشرع نمط حافظ الأسد؟
إن المقارنة بين تجربة حافظ الأسد وأحمد الشرع في التعامل مع إسرائيل تكشف عن نقاط تشابه واختلاف جوهرية، تساعدنا على فهم ما إذا كان الشرع يستنسخ نمط الأسد أم يقدم منهجًا مختلفًا. يكمن جوهر هذه المقارنة في تحليل كيفية تعامل كل منهما مع التناقض بين الأيديولوجيا والمصالح الوطنية، وفي أي سياق سياسي تحرك كل منهما.
نقاط التشابه:
1. الواقعية السياسية وتقديم المصالح الوطنية على الأيديولوجيا: هذه هي النقطة الأبرز للتشابه بين الزعيمين. حافظ الأسد، رغم انتمائه لحزب البعث ذي الأيديولوجية المناهضة لإسرائيل، أظهر براغماتية واضحة في سعيه لتحقيق مصالح سوريا العليا، خاصة استعادة الجولان واستقرار نظامه. انخرط في مفاوضات سرية وعلنية، مثل مفاوضات جنيف 1999-2000 ووثائق 1974، عندما رأى أن ذلك يخدم هذه المصالح. بالمثل، يركز أحمد الشرع على المصالح الوطنية والاستراتيجية العليا، متجاوزًا الأطر الأيديولوجية الجامدة لخلفيته الجهادية. تشير التقارير إلى مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل لـ"تهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة"، مما يدل على استعداده للتعامل الواقعي مع إسرائيل لخدمة المصالح السورية في مرحلة ما بعد الصراع.
2. التفاوض مع إسرائيل: كلا الزعيمين، رغم اختلاف خلفياتهما الأيديولوجية، انخرطا في شكل من أشكال التفاوض مع إسرائيل. الأسد بشكل مباشر وغير مباشر، والشرع أيضا بشكل مباشر غير مباشر حتى الآن. هذا يشير إلى إدراك مشترك بأن الصراع لا يمكن حله عسكريًا فقط، وأن الدبلوماسية، حتى لو كانت سرية، ضرورية لتحقيق الأهداف السياسية.
نقاط الاختلاف:
1. الخلفية الأيديولوجية: هذا هو الاختلاف الأكثر وضوحًا. حافظ الأسد جاء من حزب البعث القومي الاشتراكي، الذي كانت ايديولوجيته جزءًا لا يتجزأ من هويته السياسية، حتى لو كان يمارس الواقعية. أما أحمد الشرع، فقد تحول من قيادة تنظيم جهادي إلى رئيس انتقالي، وهو تحول يمثل قطيعة جذرية مع خلفيته الأيديولوجية السابقة. هذا التحول بحد ذاته يطرح تساؤلات حول مدى أصالة هذا التغيير، وما إذا كان تكتيكًا سياسيًا بحتًا.
2. السياق الإقليمي والدولي المتغير: حكم حافظ الأسد في فترة الحرب الباردة وما بعدها مباشرة، حيث كانت موازين القوى الدولية ثنائية القطبية إلى حد كبير، وكان الصراع العربي الإسرائيلي جزءًا من صراع أوسع بين المعسكرين الشرقي والغربي. كانت سوريا لاعبًا رئيسيًا في محور الممانعة، وتتمتع بدعم سوفيتي. أما أحمد الشرع، فيتولى الحكم في عام 2025، بعد سقوط نظام الأسد وحرب أهلية مدمرة، وفي ظل تحولات جيوسياسية كبرى في الشرق الأوسط، وتراجع فاعلية المنظمات الدولية، وصعود قوى إقليمية جديدة. السياق الحالي أكثر تعقيدًا وتعددية في الأقطاب، مما يفرض تحديات وفرصًا مختلفة تمامًا.
3. طبيعة الحكم: حافظ الأسد حكم سوريا بقبضة حديدية لمدة ثلاثة عقود، مما منحه سلطة مطلقة لاتخاذ قرارات سياسية قد تبدو متناقضة مع الخطاب الرسمي للحزب، دون خوف من معارضة داخلية كبيرة. أما أحمد الشرع، فيتولى رئاسة الجمهورية الانتقالية، مما يعني أن طبيعة حكمه قد تكون أكثر هشاشة وتأثرًا بالضغوط الداخلية والخارجية. قد يواجه تحديات في ترسيخ سلطته بنفس القدر الذي كان يتمتع به الأسد، مما قد يحد من قدرته على المناورة السياسية.
4. الشرعية والمقبولية: حافظ الأسد بنى شرعيته على الاستقرار الداخلي ومواجهة إسرائيل، وعلى الرغم من القمع، كان هناك نوع من القبول الإقليمي والدولي لنظامه كلاعب رئيسي. أما أحمد الشرع، فيواجه تحديات في بناء الشرعية والمقبولية، خاصة مع خلفيته الجهادية السابقة. يحاول تقديم نفسه كزعيم براغماتي يركز على المصالح الوطنية، ولكن الصورة النمطية عنه قد تؤثر على تعامل المجتمع الدولي معه، وتجعل مساره أكثر صعوبة [28].
في الختام، يمكن القول إن هناك تقاربًا في الأساليب بين حافظ الأسد وأحمد الشرع فيما يتعلق بالواقعية السياسية والتعامل مع إسرائيل، مدفوعًا بالمصالح الوطنية. ومع ذلك، فإن الاختلافات في الخلفية الأيديولوجية والسياق السياسي وطبيعة الحكم تجعل من الصعب القول إن الشرع يستنسخ نمط الأسد بشكل كامل. بدلاً من ذلك، قد يكون الشرع يمثل تطورًا أو تكيفًا مع واقع جديد، حيث يتم تبني البراغماتية كضرورة للبقاء وتحقيق الأهداف في بيئة إقليمية ودولية متغيرة.
الفصل الرابع: المنظومة السياسية الدولية ومستقبل منهج الشرع
4.1 التحولات الجيوسياسية بعد سقوط نظام الأسد
شهدت منطقة الشرق الأوسط، وخاصة سوريا، تحولات جيوسياسية عميقة وغير مسبوقة في السنوات الأخيرة، بلغت ذروتها بسقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. هذا الحدث المفصلي لم يغير المشهد الداخلي السوري فحسب، بل أحدث ديناميكية جديدة في العلاقات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل [29]. فبعد عقود من الاستقرار النسبي في العلاقات السورية الإسرائيلية، التي اتسمت بالعداء الظاهري مع قنوات اتصال غير مباشرة، أصبح المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة.
إن سقوط نظام الأسد أزال أحد الثوابت الرئيسية في المعادلة الإقليمية، مما أفسح المجال أمام قوى جديدة للظهور، وتغير في موازين القوى. فبينما كان نظام الأسد متحالفًا بشكل وثيق مع إيران، مما خلق محورًا للمقاومة ضد إسرائيل، فإن غيابه يثير تساؤلات حول مستقبل هذا المحور وتأثيره على الأمن الإقليمي [30]. كما أن الحرب الأهلية السورية، التي استمرت لأكثر من عقد، أدت إلى تراجع فاعلية المنظمات الدولية في حل النزاعات، مما ترك فراغًا ملأته قوى إقليمية ودولية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة [31].
في هذا السياق، برزت إشارات متعددة عن مفاوضات معلنة قد تفضي إلى اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، خاصة مع تولي أحمد الشرع رئاسة الجمهورية الانتقالية. هذا يعكس ديناميكية جديدة في المنطقة، حيث قد تتغير الأولويات وتتجه نحو الواقعية السياسية بشكل أكبر. فإسرائيل، التي كانت تتعامل مع نظام الأسد كعدو ثابت، قد تجد نفسها أمام واقع جديد يتطلب مقاربة مختلفة [32].
إن هذه التحولات الجيوسياسية لا تقتصر على العلاقات السورية الإسرائيلية، بل تمتد لتشمل المنطقة بأسرها. فالشرق الأوسط يشهد تحولات كبرى في عام 2025، مع تراجع فاعلية المنظمات الدولية في حل النزاعات وتغير موازين القوى الإقليمية. هذه التحولات تثير تساؤلات حول مستقبل النظام الدولي وتأثيره على الدول العربية، وهل ستسمح المنظومة السياسية الدولية لأحمد الشرع بالذهاب نحو تيار مختلف، أم أنها ستعيده للمنظومة السياسية العربية المتبعة منذ عام 1970 [33].
4.2 هل ستسمح المنظومة الدولية للشرع بالذهاب نحو تيار مختلف؟
يُعد السؤال حول ما إذا كانت المنظومة السياسية الدولية ستسمح لأحمد الشرع بالذهاب نحو تيار سياسي مختلف، أم أنها ستعيده إلى المنظومة السياسية العربية المتبعة منذ عام 1970، سؤالًا محوريًا يحدد مستقبل سوريا ومكانتها الإقليمية. فبعد عقود من التبعية والاصطفافات التي فرضتها ديناميكيات الحرب الباردة، ثم مرحلة القطبية الواحدة، يواجه الشرع تحديًا كبيرًا في صياغة سياسة خارجية مستقلة تتناسب مع منهجه البراغماتي.
إن المنظومة السياسية الدولية، بما فيها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، والقوى الإقليمية المؤثرة، لديها مصالح لا يمكن أن تتبدل في الشرق الأوسط. هذه المصالح غالبًا ما تتجاوز التغيرات الداخلية في الدول، وتسعى للحفاظ على نوع من الاستقرار الذي يخدم أجنداتها. فإذا كان منهج الشرع يهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية السورية العليا، فإن هذا قد يتصادم مع مصالح بعض هذه القوى، مما قد يفرض قيودًا على حركته [34].
على سبيل المثال، قد تسعى بعض القوى الدولية إلى إعادة سوريا إلى "المنظومة السياسية العربية المتبعة منذ عام 1970"، والتي اتسمت بالاصطفافات التقليدية، والتعامل مع إسرائيل من منظور معين، والالتزام بحدود معينة في السياسة الخارجية. هذا قد يعني الضغط على الشرع لتبني سياسات تتوافق مع هذه المنظومة، أو مواجهة العزلة والضغوط الاقتصادية والسياسية [35].
من ناحية أخرى، قد ترى بعض القوى الدولية في منهج الشرع البراغماتي فرصة لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي بطريقة تخدم مصالحها. فإذا كان الشرع مستعدًا للتفاوض مع إسرائيل، وتجنب الصراعات الإقليمية، والتركيز على الاستقرار الداخلي، فقد تجد فيه هذه القوى شريكًا محتملًا. هذا يعتمد بشكل كبير على قدرة الشرع على إقناع المجتمع الدولي بجدية تحولاته، وقدرته على بناء الثقة مع الأطراف المختلفة [36].
إن دور القوى الإقليمية والدولية في تشكيل مستقبل سوريا سيكون فاصلاً. فإيران، التي كانت حليفًا رئيسيًا لنظام الأسد، قد تسعى للحفاظ على نفوذها في سوريا، مما قد يضع الشرع في موقف صعب بين مصالح إيران ومصالح الدول الأخرى. كما أن تركيا، التي لديها مصالح أمنية واقتصادية في سوريا، قد تلعب دورًا في تحديد مسار الشرع. بالإضافة إلى ذلك، فإن دول الخليج، التي بدأت في إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد، قد تمارس ضغوطًا اقتصادية وسياسية لتوجيه سياسة الشرع.
في النهاية، فإن قدرة الشرع على الذهاب نحو تيار مختلف ستعتمد على عدة عوامل: أولاً، مدى قوته الداخلية وقدرته على توحيد الصف السوري خلف منهجه. ثانيًا، مدى مرونته في التعامل مع الضغوط الخارجية، وقدرته على إيجاد توازنات بين مصالح القوى المختلفة. ثالثًا، مدى استعداد المجتمع الدولي لتقبل تحولاته ومنحه الفرصة لتقديم نموذج سياسي جديد. إنها معادلة معقدة، ومستقبل منهج الشرع لا يزال غير مؤكد، ولكنه بالتأكيد سيشكل نقطة تحول في تاريخ سوريا والمنطقة.
الخاتمة
في ختام هذا البحث المعمق لتجربتي حافظ الأسد وأحمد الشرع في التعامل مع إسرائيل، يتضح أن المشهد السياسي السوري والإقليمي يتسم بتعقيدات تتجاوز الأطر الأيديولوجية الجامدة. لقد أظهر كل من الزعيمين، وإن اختلفت خلفياتهما وسياقاتهما، قدرة على تبني الواقعية السياسية عندما تقتضي المصالح الوطنية العليا ذلك.
لقد استطاع حافظ الأسد، رغم أيديولوجية حزب البعث المناهضة لإسرائيل، أن ينخرط في مفاوضات سرية وعلنية، مدفوعًا بمصلحة استعادة الجولان واستقرار نظامه. هذه البراغماتية سمحت له بالحفاظ على سوريا كلاعب إقليمي مهم لثلاثة عقود. في المقابل، يمثل أحمد الشرع تحولًا لافتًا من خلفية جهادية إلى خطاب سياسي يركز على المصالح الوطنية والاستراتيجية، ويظهر استعدادًا للتفاوض مع إسرائيل، حتى وإن كان ذلك عبر وسطاء.
إن نقاط التشابه بين التجربتين تكمن في تقديم المصالح الوطنية على الأيديولوجيا، والاستعداد للتفاوض مع الخصم عندما يخدم ذلك هذه المصالح. أما نقاط الاختلاف، فتتجلى في الخلفية الأيديولوجية المتباينة، والسياق الإقليمي والدولي المتغير جذريًا بعد سقوط نظام الأسد والحرب الأهلية، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة الحكم (شمولي مقابل انتقالي). هذه الاختلافات تجعل من الصعب القول إن الشرع يستنسخ نمط الأسد بشكل كامل، بل هو يمثل تكيفًا مع واقع جديد، حيث أصبحت البراغماتية ضرورة للبقاء وتحقيق الأهداف في بيئة جيوسياسية معقدة.
إن المنظومة السياسية الدولية، بما فيها القوى الكبرى والإقليمية، ستلعب دورًا قوياً في تحديد مستقبل منهج الشرع. فهل ستسمح له بالذهاب نحو تيار مختلف يعتمد على المصالح الوطنية البحتة، أم أنها ستعيده إلى المنظومة السياسية العربية التقليدية التي اتسمت بالاصطفافات والقيود؟ هذا السؤال لا يزال مفتوحًا، ويعتمد على قدرة الشرع على بناء الشرعية الداخلية والخارجية، وقدرته على المناورة بين مصالح القوى المتنافسة.
في النهاية، يمكن القول إن تجربة أحمد الشرع، وإن كانت تحمل بعض أوجه التشابه مع براغماتية حافظ الأسد، إلا أنها تمثل "صيغة سورية خالصة" في العمل السياسي، تتأثر بالواقع الإقليمي والدولي المتغير. إنها تجربة تسعى لتثبيت البوصلة وسط اضطراب المشهد وتحقيق الأهداف الوطنية بعيدًا عن الأوهام أو التشنجات، ولكنها ستظل رهينة لتوازنات القوى الإقليمية والدولية التي تشكل مستقبل سوريا والمنطقة.










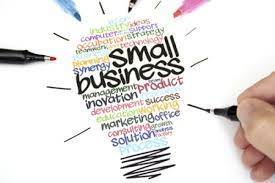

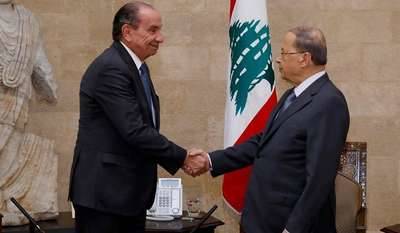

 08/23/2025 - 12:34 PM
08/23/2025 - 12:34 PM





Comments